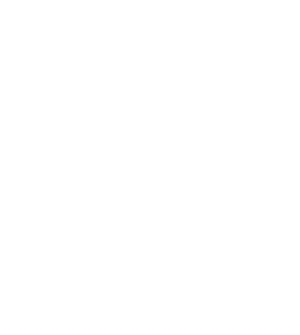22 الاعلامي - د. محمد يوسف حسن بزبز / سفير جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي
في زمن التحول الرقمي المتسارع، غزت المنصات التعليمية بيوت الناس كما لو أنها المُنقذ المنتظر للعملية التربوية، والمفتاح السحري لتفوق الأبناء ونجاحهم. روّج لها البعض على أنها البديل الحديث للمدرسة، ووسيلة الخلاص من مشكلات التعليم التقليدي. لكن الحقيقة التي غفل عنها كثيرون، أن هذه المنصات – في غالبيتها – تحوّلت إلى تجارة تربوية مشوهة، أربكت المشهد، وأثقلت كاهل الأسر، وأضعفت من مكانة المدرسة، وقوّضت مفهوم التربية الحقيقي.
ما إن بدأت تلك المنصات بالانتشار، حتى تسابقت الأسماء، وتعددت الشعارات، وتفاوتت الأسعار، واختلط الغث بالسمين. كل منصة تدّعي التفوق، وتُزيّن واجهتها بأسماء مدرسين "نجوم"، وإعلانات براقة، ووعود بالعلامات الكاملة، حتى أصبح الطالب يعيش في دوامة من الخيارات والمقارنات، والولي في صراع دائم بين قدرته المالية وحرصه على مستقبل أبنائه.
لقد تغيّر مركز الثقل في العملية التعليمية، فبدلاً من أن تكون المدرسة هي المحور، والمنهاج هو المرجع، والمعلّم هو القائد، أصبحت المنصة هي الصانع الجديد للتفوق، والمعلّم فيها هو البائع، والطالب هو الزبون الذي يدفع مقابل خدمة رقمية لا تخضع لمعيار واضح للجودة أو الالتزام.
يومًا بعد يوم، بات اعتماد الطلاب على المنصات أكبر من اعتمادهم على المدرسة، مما أضعف الحضور العقلي والتربوي في الصفوف، وفكك الصلة بين الطالب ومعلمه، وعمّق الشعور بعدم الثقة بالمؤسسة التعليمية الرسمية. وفي هذا السياق، ظهرت فئة من المعلمين هجرت واجبها في المدرسة، لتظهر على المنصات بمظهر "النجم التجاري"، يُقدم ما يشبه الخدمة التعليمية، لا ما يستحق أن يُدعى تربية أو تعليمًا.
لقد أفرزت هذه الظاهرة طبقية جديدة في التعليم، حيث بات تحصيل الطالب مرتبطًا بقدرة ولي أمره على الاشتراك في منصة أو أكثر. أما الطالب الفقير، فقد تركته السوق التعليمية الرقمية على الهامش، يتعثر في طريقه، ويعيش شعور النقص والخذلان، وكأن التفوق حكرٌ على المقتدرين فقط.
وفي خضم هذا التنافس غير المنظم، بدأ الطالب يفقد التركيز، ويتشتت ذهنيًا بين عشرات المحتويات، ومئات المقاطع، وأسلوب كل معلم في الشرح. حتى ضاع المفهوم التربوي، وساد حفظ الأجوبة الجاهزة، وغاب التفكير النقدي، وتشوّهت صورة الامتحان، وأصبحت الغاية هي العلامة، لا الفهم، ولا التعلم الحقيقي.
أما الأسرة، فقد أصبحت تعيش تحت ضغط نفسي ومالي هائل، إذ وجدت نفسها مجبرة على مجاراة هذا الواقع الجديد، خوفًا من تراجع أبنائها، أو تأثرهم بالموجة العامة، فتراها تدفع وتدفع، على حساب أولوياتها، وأحيانًا على حساب كرامتها، تحت وطأة المقارنة المجتمعية، والنقد اللاذع إن لم تُساير ما بات يُسمى "الضرورة التعليمية الجديدة".
إننا أمام مشهد ضبابي، تتداخل فيه الأهداف، وتُختزل فيه المعايير، ويُروّج فيه للتفوق الوهمي. وقد أصبح من الضروري الوقوف أمام هذه الظاهرة بوعي وجرأة، وإعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية، وفرض تنظيم واضح لهذه المنصات، يضمن ضبط المحتوى، ومعايير الجودة، وسقف الأسعار، وحماية الطالب والأسرة من هذا الجشع المقنّع.
ليس من العدل أن نُحمّل المنصات كل أسباب الخلل، لكنها دون أدنى شك أصبحت جزءًا من أزمة عميقة تعصف بالتعليم، خاصة حين تُترك دون رقابة، وتُمارس دورها في الخفاء، وتعمل بمنطق السوق لا بمبدأ الرسالة. فالمعلم حين يتحول إلى بائع، والمحتوى إلى سلعة، والطالب إلى رقمٍ في حسابٍ مالي، فاعلم أننا نفقد التعليم، ونُفرغ التربية من مضمونها.
لقد آن الأوان للوزارة، وللمجتمع، أن يتدخل. آن للسياسات أن تُعيد تنظيم هذا الفضاء العشوائي. آن للقانون أن يضع ضوابط واضحة، تُعيد التوازن إلى العلاقة بين المدرسة والمنصة، وتُعيد للطالب مكانه الطبيعي داخل أسوار المدرسة، وللمعلم هيبته، وللتعليم رسالته.
وفي الختام، لنتذكر أن المنصة مهما بلغت من تطور، لا يمكنها أن تُعوض دفء العلاقة التربوية داخل الصف، ولا يمكنها أن تُشكّل وجدان الطالب، أو تبني شخصيته، أو ترعى القيم، أو تزرع الانتماء. المدرسة ليست فقط مكانًا للتعليم، بل هي بيئة إنسانية تُصقل العقول، وتُربي النفوس، وتُخرّج القادة.
فليكن صوتنا واحدًا: نعم للتكنولوجيا الداعمة، لا للتجارة المُستترة في ثياب التعليم.