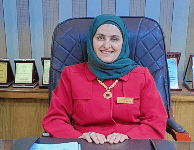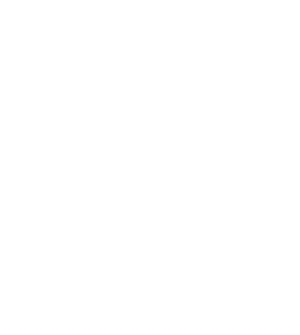بقلم : الدكتورة أنوار جعفر عبدالنبي / جامعة جدارا
في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن شبكات التواصل الاجتماعي لم تعد مجرد أدوات للتسلية أو تبادل الصور والمقاطع، بل تحولت إلى ساحات فكرية، ومنصات للتأثير العميق في سلوك الأفراد، خاصة فئة الشباب. في الأردن، كما في دول العالم، تنتشر هذه المنصات بشكل واسع بين طلاب الجامعات، حيث يقضون ساعات طويلة يوميًا على تطبيقات مثل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك ويوتيوب. ورغم أن هذه المنصات فتحت المجال أمامهم للتعبير والتواصل والتعلم، إلا أنها في الوقت ذاته أصبحت بيئة خصبة لانتشار أنواع مختلفة من الخطاب، من بينها الفكر المتطرف، الذي بدأ يجد طريقه تدريجيًا إلى عقول بعض الشباب الجامعي.
الفكر المتطرف لا يظهر فجأة أو بشكل مباشر، بل يتسلل إلى الأذهان عبر محتوى يبدو في ظاهره بريئًا أو مثيرًا للتفكير. قد يبدأ الأمر بمقطع فيديو قصير يحمل تساؤلًا عن العدالة أو الهوية أو الظلم، ثم يتبعه اقتراح خوارزمي لمحتوى أكثر تطرفًا، ومع الوقت، يدخل الطالب في دائرة من "غرف الصدى"، حيث لا يرى إلا نوعًا واحدًا من الخطاب، يتكرر بصيغ مختلفة، حتى يصبح مألوفًا، بل ومقبولًا في ذهنه.
طلاب الجامعات الأردنية يعيشون في بيئة معقدة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. فالكثير منهم يواجه تحديات في إيجاد فرصة عمل بعد التخرج، أو يشعر بعدم التأثير في القرار العام، أو يمر بتجربة اغتراب فكري نتيجة التحولات الثقافية السريعة. هذا الواقع يجعل بعض الطلاب أكثر عرضة للتأثر بخطابات تعدهم بتفسير بسيط للعالم، وتحمل لهم وعودًا بالحقيقة أو القوة أو الخلاص، وكلها سمات يتم توظيفها بذكاء من قبل الجهات التي تنشر الفكر المتطرف عبر الإنترنت.
إن ما يجعل شبكات التواصل أداة خطيرة في هذا السياق هو أنها تعمل بلا رقابة حقيقية. فالطالب يستطيع إنشاء حساب خاص، والانضمام إلى مجموعات مغلقة، ومتابعة حسابات ذات توجهات متشددة، دون أن يلاحظ أحد من حوله ذلك. ومع غياب توعية كافية حول مخاطر هذا النوع من المحتوى، وانشغال الأسرة والجامعة عن الدور التوعوي، يصبح الطالب هدفًا سهلًا للخطاب المتطرف.
الأساليب التي تتبعها الجهات المتطرفة على هذه المنصات لم تعد تقليدية أو فجة، بل أصبحت تعتمد على خطاب ناعم، يستخدم لغة عاطفية، ورسومًا جذابة، ومقاطع مرئية مشوّقة، وأحيانًا مؤثرة نفسيًا. يظهر المتطرف في شكل ناصح، أو شخص غاضب من الظلم، أو شاب يروي تجربته “الملهمة” في الهروب من الواقع إلى “الحقيقة”. هذه القصص المصنوعة بعناية تلعب على أوتار الهوية والانتماء والدين، وتستغل مشاعر الشاب الجامعي الذي لا يزال يبحث عن موقعه في هذا العالم.
في السياق الأردني تحديدًا، لا يمكن تجاهل الأثر الذي تركته الظروف الإقليمية، خاصة بعد موجات التطرّف التي ظهرت في العقد الماضي في دول الجوار. ورغم أن الأردن تمكن من حماية شبابه إلى حدّ كبير من الوقوع في فخ التنظيمات الإرهابية المسلحة، إلا أن التطرف كفكر لا يزال يشق طريقه بهدوء، خاصة على المستوى الفردي، وعبر المنصات الرقمية. وظهر ذلك في بعض الحالات التي تورط فيها شبان جامعيون في نشاطات أو أفكار مخالفة للقانون، ثبت لاحقًا أن مصدرها لم يكن المسجد أو الكتاب، بل مواقع الإنترنت ومقاطع الفيديو.
الحرم الجامعي في الأردن، الذي يُفترض أن يكون بيئة آمنة للحوار والتنوع، قد يصبح في بعض الحالات ساحة لصدامات فكرية، أو لتأثير بعض الطلاب المتشددين على زملائهم. وقد لاحظ بعض الأساتذة في الجامعات أن هناك طلابًا يبدؤون فجأة في الانسحاب من الأنشطة، أو إظهار مواقف عدائية تجاه زملائهم المخالفين، أو ترديد عبارات ذات طابع متشدد لا تتماشى مع روح الجامعة. وفي حالات قليلة، ظهرت منشورات إلكترونية لبعض الطلبة تحمل أفكارًا متطرفة، قبل أن تتدخل الجهات المعنية بالمتابعة أو التصحيح.
ورغم الجهود التي تبذلها بعض الجهات الرسمية، مثل الأجهزة الأمنية والمؤسسات الدينية، في توعية الشباب، إلا أن هذه الجهود لا تزال محدودة داخل أسوار الجامعات، وغالبًا ما تأتي على شكل محاضرة واحدة أو حملة موسمية، لا تترك أثرًا مستدامًا. كذلك، فإن غياب الحوار المفتوح داخل الحرم الجامعي، والخوف من مناقشة بعض المواضيع "الحساسة"، يدفع بعض الطلاب للبحث عن إجاباتهم في فضاء الإنترنت، حيث لا رقابة، ولا مرشد، ولا من يصحح المفاهيم.
الأمر لا يتوقف عند ذلك، بل هناك جانب نفسي مهم جدًا. بعض الطلاب الذين يعيشون تجارب شخصية صعبة، سواء كانت مادية أو اجتماعية أو عاطفية، قد يشعرون بالضعف أو باللاجدوى، وهنا يصبح الخطاب المتطرف جذابًا، لأنه يعدهم بقوة داخلية، وهدف نبيل، وجماعة ينتمون لها، وهو ما يفتقدونه في محيطهم الواقعي. وهكذا، يتحول تطرفهم إلى وسيلة للهروب، أو لتعويض شعورهم بالنقص.
لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعّال، لا بد من تغيير جذري في طريقة تعامل الجامعات والمؤسسات مع هذه الفئة العمرية. أولًا، يجب أن تتضمن المناهج الجامعية موادًا كالتربية الاعلامية تدرّس مهارات التفكير النقدي، والتحقق من الأخبار، والتحليل الإعلامي، حتى يتمكن الطالب من التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة. ثانيًا، لا بد من وجود مراكز إرشاد نفسي فاعلة داخل الجامعات، تقدم الدعم الحقيقي للطلبة، لا مجرد خدمات شكلية. وثالثًا، يجب على الجامعات أن تخلق مساحات حوار حقيقية بين الطلبة، تتيح لهم التعبير عن أفكارهم دون خوف أو حكم مسبق، حتى لا يلجأوا للانطواء أو التطرف كرد فعل.
من جهة أخرى، يقع على عاتق الأسرة أيضًا دور مهم في مراقبة نوع المحتوى الذي يتابعه أبناؤها على الإنترنت، دون أن يتحول ذلك إلى رقابة خانقة. المطلوب هو حوار مفتوح، ومتابعة ذكية، تبني الثقة وتُعزز الوعي، بدلًا من القمع أو التجاهل. وإذا أحسّ الأهل أن ابنهم يمرّ بتغيرات فكرية أو سلوكية مفاجئة، فعليهم أن يتعاملوا مع الأمر بحكمة، ويطلبوا مساعدة مختصين عند الحاجة.
أما على مستوى الدولة، فمن الضروري تطوير سياسات شاملة تتعامل مع خطر التطرف الإلكتروني كقضية أمن فكري وليست مجرد مخالفة قانونية. وهذا يشمل تعزيز الرقابة على المنصات الرقمية، بالتعاون مع الشركات الكبرى، وتطوير محتوى إعلامي موجه للشباب، يحاكي أساليب التواصل الحديثة التي يستخدمها المتطرفون، لكن بلغة إيجابية وعلمية ومقنعة.
في النهاية، يمكن القول إن شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة طلاب الجامعات الأردنية، ولا يمكن فصلهم عنها. لكنها في الوقت ذاته سلاح ذو حدين، يمكن أن تُستخدم للتنوير، أو للتضليل. والتحدي الحقيقي ليس في منعهم من استخدامها، بل في تمكينهم من التعامل معها بوعي ومسؤولية. لأن الطالب الذي يمتلك تفكيرًا ناقدًا، وانتماءً إيجابيًا، ودعمًا نفسيًا واجتماعيًا، سيكون حصينًا أمام أي محاولة للتأثير عليه، مهما كانت مغرية أو متقنة.