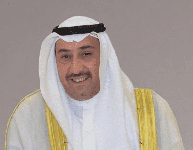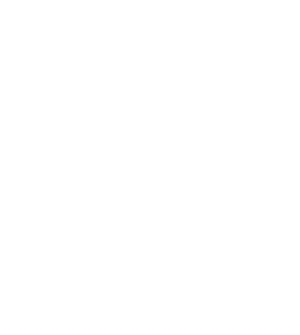بقلم : د.ثروت المعاقبة
في عصرنا الحالي، تتسارع فيه المتغيرات وتتزايد فيه التحديات، لم يعد النجاح يُقاس بجهود الأفراد المنفردة، بل بقدرة المؤسسات على العمل المنظَّم والمتكامل الذي يقوم على التخطيط، والتعاون، والحوكمة الرشيدة، فالعمل المؤسسي لم يعد مجرد أسلوب إداري، بل أصبح ثقافة تنظيمية شاملة تقوم على وضوح الأدوار والمسؤوليات، استمرارية الأداء، وتكامل الجهود نحو هدف مشترك.
إن جوهر العمل المؤسسي يكمن في تحويل الفكر الفردي إلى أداء جماعي منظم، تُدار فيه الطاقات البشرية والموارد بطريقة تحقق الكفاءة والفاعلية، فالمؤسسة الناجحة هي تلك التي لا تعتمد على الأشخاص بقدر ما تعتمد على النظام والإجراءات والمعايير التي تضمن لها البقاء والتطور، حتى في غياب الأفراد المؤثرين، ولا تتبنى الآراء الشخصية دون معايير واضحة.
ومن هنا، فإن تبنّي منهج العمل المؤسسي هو الطريق نحو التميز والاستدامة، لأنه يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة، ويخلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والمساءلة، مما يجعل الإنجاز مؤطرًا بالقيم والنتائج لا بالعشوائية أو الاجتهاد الفردي، حيث أصبح النجاح عملية منهجية تقوم على التخطيط، والقياس، والتقويم المستمر، فالتجارب التي تنفذها المؤسسات، سواء كانت مشاريع تطويرية أو مبادرات جديدة، لا تُعد ناجحة بمجرد تنفيذها فقط، بل حين تتحقق أهدافها ورؤيتها ورسالتها ضمن معايير واضحة وأدوات قياس دقيقة.
تسعى المؤسسات الرائدة إلى وضع معايير دقيقة لقياس نجاح التجارب والمبادرات، لضمان أن النتائج المتحققة تعبّر فعلًا عن الإنجاز الحقيقي لا عن الحظ أو الجهد العشوائي، وتعد هذه المعايير الركائز الأساسية التي يُبنى عليها التقييم المؤسسي السليم، وأول هذه المعايير هو الملاءمة (Relevance)، أي مدى توافق التجربة مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ورسالتها العامة، بحيث تنسجم مع رؤيتها الكبرى ولا تكون منفصلة عنها. يليها الفاعلية (Effectiveness)، التي تعبّر عن مدى تحقيق التجربة للأهداف المخططة ضمن الإطار الزمني المحدد. أما الكفاءة (Efficiency) فتركّز على استخدام الموارد بطريقة مثلى لتحقيق أعلى إنتاجية بأقل تكلفة ممكنة، مما يعكس حسن إدارة الوقت والموارد، ويأتي بعد ذلك معيار الأثر (Impact) الذي يقيس ما أحدثته التجربة من نتائج إيجابية ملموسة أو غير ملموسة على المستفيدين وبيئة العمل، سواء على المدى القصير أو الطويل. وأخيرًا، تمثّل الاستدامة (Sustainability) قدرة التجربة على الاستمرار وتقديم قيمة مضافة حتى بعد انتهاء مرحلة التنفيذ الأولى.
إن اجتماع هذه المعايير الخمسة يشكّل منظومة متكاملة تتيح للمؤسسات تقييم تجاربها بموضوعية وشفافية، وتحويل النتائج إلى خبرات تراكمية تدعم مسيرة التطوير والتميز المؤسسي.
ويُعد قياس النجاح في المؤسسات عملية علمية دقيقة تتطلب وجود مؤشرات أداء واضحة ومحددة مسبقًا تُعرف باسم Key Performance Indicators (KPIs)، وهي التي تمكّن المؤسسة من متابعة التقدّم وتقييم مدى تحقيق الأهداف.
وتنقسم هذه المؤشرات إلى نوعين رئيسيين: مؤشرات كمية تقيس الإنجاز بالأرقام مثل نسب التنفيذ، معدلات النمو، حجم العائد، أو عدد المستفيدين من البرامج، ومؤشرات نوعية تركز على الجوانب غير الملموسة كدرجة رضا الموظفين والعملاء، وجودة الخدمات المقدمة، ومستوى الإبداع والابتكار في الأداء.
ولتحقيق دقة القياس، تستخدم المؤسسات مزيجًا من الأدوات المتنوعة، مثل الاستبانات والمقابلات لجمع آراء المشاركين والمستفيدين، والتقارير الإحصائية لمتابعة نسب الأداء والنتائج، والملاحظة الميدانية لتقييم مدى تطبيق التجارب على أرض الواقع، إلى جانب تحليل التغذية الراجعة (Feedback Analysis) الذي يساعد على اكتشاف نقاط القوة والضعف وتوجيه التحسين المستقبلي. ومن خلال هذا التكامل في المؤشرات والأدوات، تتمكن المؤسسة من تحويل النتائج إلى بيانات قابلة للتحليل، تُبنى عليها قرارات تطويرية دقيقة وموضوعية تعزز جودة الأداء وتدعم مسيرة النجاح المستدام.
ولكي تنجح أي تجربة مؤسسية، لا بد أن تستند إلى مجموعة من الأدوات الإدارية والتنظيمية التي تضمن حسن التنفيذ ودقة المتابعة، ويُعد التخطيط الاستراتيجي الخطوة الأولى في هذا المسار، إذ يتم من خلاله تحديد الأهداف والمراحل والنتائج المتوقعة بدقة قبل البدء بالتنفيذ، كما تُعتبر إدارة الوقت والموارد عنصرًا محوريًا لضمان توزيع الجهد والتمويل بطريقة فعالة تسهم في تحقيق الكفاءة التشغيلية، ولا يمكن للتجارب المؤسسية أن تحقق أهدافها دون فرق عمل متخصصة تمتلك الخبرة والتكامل المعرفي، إذ يعتمد نجاح المؤسسة على التعاون الجماعي أكثر من الجهود الفردية.
وإلى جانب ذلك، تلعب إدارة المخاطر دورًا مهمًا في توقع العقبات المحتملة ووضع الخطط البديلة لمواجهتها قبل أن تؤثر في سير العمل، كما تبرز أهمية المتابعة والتقييم المستمر في مراقبة الأداء في كل مرحلة لضمان التقدم في الاتجاه الصحيح، بينما تُعد نظم المعلومات وسيلة جوهرية لجمع وتحليل البيانات بشكل دوري لتوجيه القرارات وصنع السياسات المؤسسية على أسس علمية. إن تكامل هذه الأدوات لا يضمن فقط نجاح التجربة، بل يحوّلها إلى نموذج يُحتذى به داخل المؤسسة وخارجها، ويعزز ثقافة التميز والاستدامة في الأداء.
أصبحت المؤسسات الحديثة، ولا سيما تلك التي تتبنى مبادئ الحوكمة والجودة الشاملة، تعتمد بشكل متزايد على المعايير العلمية في تقييم تجاربها، إذ لم تعد تكتفي بالملاحظات العامة أو الأحكام الانطباعية، بل تستخدم أطرًا تقييمية واضحة مثل نموذج التميز الأوروبي (EFQM)، وبطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)، ونظام إدارة الجودة (ISO 9001). وتوفّر هذه الأنظمة إطارًا موضوعيًا يساعد المؤسسات على تحديد مكامن القوة والضعف، وتوثيق الدروس المستفادة من التجارب السابقة، وتعزيز ثقافة التحسين المستمر في بيئة العمل.
وفي المقابل، ما زالت بعض المؤسسات تقيّم تجاربها بناءً على الانطباعات الشخصية أو القرارات الفردية، مما يؤدي إلى فقدان العدالة في التقييم وضياع فرص التطوير، والنتيجة أن المؤسسة التي تعتمد على المعايير العلمية تتعلم وتنمو، بينما التي تفتقر إليها تكرر الأخطاء نفسها.
نجاح التجارب في المؤسسات لا يُقاس فقط بما تحقق من أرقام، بل بما أحدثته من أثر مستدام وتغيير إيجابي. حين تضع المؤسسة معايير دقيقة، وأدوات قياس فعالة، وتلتزم بالتقييم العلمي، فإنها تحوّل كل تجربة إلى درس قيادي ومصدر إلهام للتطوير.
أما المؤسسة التي تُهمل القياس والمعايير الرسمية، وتعتمد على الآراء الشخصية والانطباعات الفردية في تقييم تجاربها ومشاريعها، فتواجه صعوبة بالغة في تحقيق التقدم المستدام. فغياب الأطر الموضوعية يجعل القرارات متأثرة بالعوامل الذاتية، مما يؤدي إلى فقدان العدالة في التقييم، وضياع فرص التطوير، وتكرار الأخطاء نفسها.
فالتميز لا يأتي من الصدفة، بل من الوعي، والتخطيط، والقياس، والتعلم من التجارب