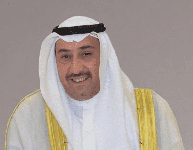بقلم: آلاء سلهب التميمي
ليس أقسى على الإنسان من أن يعطي عمره كلّه، ثم يُكافأ بالجحود.
وأن تبني بيتًا حجرًا حجرًا، وتغرس روحك في أبنائك، ثم تكتشف – في خريف العمر – أنّك قد أصبحت عبئًا ثقيلًا في نظر من كنتَ يومًا عالمهم كلّه.
هذه ليست مبالغة عاطفية، بل واقع يتكرّر بصمت داخل بعض البيوت.
ما نعيشه اليوم ليس مجرّد قصص فردية عن عقوق هنا أو نكران هناك، بل أزمة قيم اخلاقية ودينية، عنوانها اختلال في مفهوم الأسرة ودورها.
والسؤال المؤلم الذي لا بدّ منه: هل الأبناء وحدهم المسؤولون؟
أم أننا – نحن الآباء والأمهات – شاركنا، بوعي أو بغير وعي، في صناعة هذا الخذلان؟
عندما يتحول البيت إلى محطة عبور وتقليد للغرب، لا إلى احتواء ، يخسر الأبناء الإحساس بالأمان.
وعندما انشغلنا بالركض خلف متطلبات الحياة، ظنًّا منّا أننا نحمي مستقبلهم، نسينا أن الطفل لا يعيش بالخبز وحده، بل بالكلمة، وبالنظرة، وبالوقت.
نعم المال قد يسدّ حاجة، لكنه لا يبني إنسانًا.
لست ضد عمل المرأة، ولا ضد طموحها، لكن الخلل يبدأ حين يصبح العمل بديلًا عن الدور التربوي، لا مكمّلًا له.
الأم ليست موظفة في بيتها، بل صانعة وجدان ومستثمره في صحه أبنائها النفسية والعقلية والعاطفية.
وحين يُترك هذا الدور للشاشات، أو للشارع، أو لثقافة سريعة الاستهلاك، فلا نستغرب أن يكبر الأبناء بلا جذور أو مبادئ.
كما أنّنا – باسم “التربية الحديثة” والتقليد الأعمى للقالب الغربي– خففنا الجرعات الأساسية من الحزم، حتى باتت كلمة “لا” قاسية في نظرنا، بينما هي في حقيقتها صمّام أمان.
فخرج جيل يعرف حقوقه بدقة، ويجهل واجباته تمامًا، جيل يطالب ولا يعترف، ويأخذ ولا يشكر.
وحين غاب البعد القيمي والديني عن التربية، لم يعد برّ الوالدين قيمة راسخة، بل خيارًا قابلًا للنقاش.
وأصبح الوالدان للأسف في نظر بعض الأبناء “مموّلين” لا أكثر، تنتهي صلاحيتهم بانتهاء قدرتهم على العطاء المادي.
ثم نأتي إلى أخطر ما في المشهد: غياب القدوة.
كيف نطلب من الأبناء الاحترام، وهم يشاهدون الصراع الدائم بين الأب والأم؟
كيف نزرع الامتنان، ونحن نختلف أمامهم على من قدّم أكثر ومن ضحّى أكثر؟
الطفل لا يتربّى بالخطب، والمواعظ بل بالمشهد اليومي الذي يراه في البيت.
الحصاد، للأسف، مرّ.
جيل يشعر بالاستحقاق الدائم، يرى تضحيات والديه أمرًا مفروغًا منه، لا يستوجب الشكر ولا الوفاء.
جيل قد يترك والديه وحيدين، لا لأنه قاسٍ بالفطرة، بل لأنه لم يتعلّم يومًا معنى العطاء.
إصلاح هذا الخلل لا يكون بالمزيد من المال، ولا بالمزيد من التنازلات.
يكون بالعودة إلى الأساس: أسرة حاضرة، وأدوار واضحة، وقيم ثابتة، ودين يُربّي قبل أن يُدرَّس.
أمّ تدرك أن أعظم إنجازاتها هو بناء الإنسان، وأب يعرف أن القيادة ليست إنفاقًا فقط، بل حضور وتوجيه وقدوة.
إن لم نراجع أنفسنا اليوم، فسنجد أنفسنا غدًا نشتكي من جيلٍ نحن – بصراحة مؤلمة – من صنع ملامحه.
وحينها، لن يكون الخذلان قَدَرًا… بل نتيجة.
لذا فلابد أن نعود إلى التربية الواعية قبل أن نبحث عن الأبناء المطيعين.
أن نُربّي بالقدوة لا بالأوامر، وبالحضور لا بالتعويض، وبالعدل لا بالإفراط ولا بالتفريط.
أن نزرع في نفوس أبنائنا منذ الصغر معنى الشكر، وقيمة البرّ، وحدود الاحترام، وأن نفهمهم أنّ الحقوق لا تُؤخذ بلا واجبات، وأن الحبّ الحقيقي ليس دلالًا دائمًا بل مسؤولية وتشاركية.
التربية الناجحة لا تصنع أبناءً بلا أخطاء، لكنها تصنع أبناءً يعرفون طريق الرجوع، ويشعرون أن والديهم ليسوا عبئًا في خريف العمر، بل أصل الحكاية وجذورها وبرهم واجب لدخول الجنة.
وفي الميزان الإلهي لا تُقاس العلاقات بالعاطفة وحدها، بل بالطاعة والوفاء.
فقد قرن الله تعالى شكره بشكر الوالدين، فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾، وجعل الإحسان إليهما عبادة لا تُؤجَّل ولا تُبرَّر، فقال تعالى: ﴿وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾.
كما وأوصى النبي ﷺ بالوالدين بقوله: «رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد».
فمن أراد تربية صالحة، فليغرس في قلب أبنائه أن برّ الوالدين طريق رضوان الله، وأن العقوق ليس مجرد خطأ اجتماعي بل خسارة دينية وأخلاقية، وأن من لا يحفظ الجميل في بيته، لن يعرف الوفاء خارجه والدائرة تدور فمثلما تزرع ستحصد.